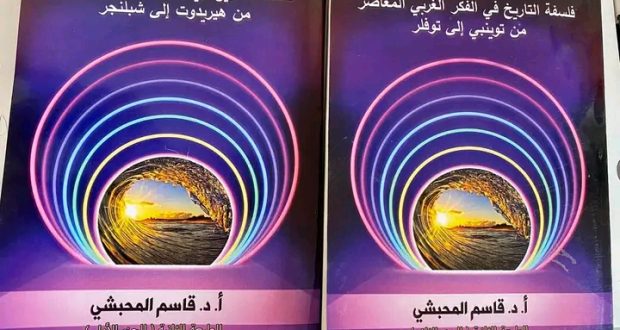بروفيسور / قاسم المحبشي..
اهتم توينبي بحياة النبي محمد وطبيعة دعوته في سياق تحليله عملية نشوء الحضارة الإسلامية وتطورها محاولاً في ذلك تطبيق قانون (الانعزال والعودة) الذي عده توينبي المفتاح الأساس لتعرف الشخصيات العظيمة في التاريخ ودورها في عملية نشوء وارتقاء الحضارات. يقول توينبي: “كان لعبقرية النبي محمد صلعم أثر كبير في نقل رسالة ربه إلى قومه، وقد كان تاريخ الجزيرة مرتبطاً بذلك..
فمنذ أن دجن الجمل قبل أيام محمد بنحو ألفي سنة، أصبحت الجزيرة العربية مما يمكن اجتيازه من مكان إلى آخر. وأخذت الآراء والتنظيمات والمذاهب تتغلغل إلى شبه الجزيرة من الهلال الخصيب، وفي عصر النبي كانت الشحنة الروحية المتراكمة في الجزيرة العربية على وشك الانفجار. وجاءت رسالة محمد في الوقت المناسب إذ تلقى هذه الشحنة فأحسن استعمالها. وذلك برؤيته النيرة وتصميمه r وحكمته”…
يعتقد توينبي بأن حياة محمد ودعوته سارت في مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة العزلة والاعتكاف.
والمرحلة الثانية: مرحلة العودة والظهور.
المرحلة الأولى: ولا يقصد توينبي بمرحلة الاعتكاف هنا اعتكاف محمد r المعروف في غار حراء، حينما كان يتلقى وحي ربه، بل أن المرحلة الأولى من حياة محمد عند توينبي هي المرحلة الدينية الخالصة، التي كرس فيها الرسول نفسه لبث دعوته الجديدة وقد شرع يحقق مهمته وهو في الأربعين من عمره (6.9م) بعد (عودته) من اعتكاف دام خمسة عشر عاماً طاف خلالها في موكب القوافل التجارية الضاربة بين واحات الجزيرة العربية والمحطات الرومانية في الصحراء السورية، وذلك لحساب السيدة خديجة، التي أصبحت زوجته فيما بعد، ولما تلقى محمد r الوحي أول مرة نحو (610م) كان قد تزوج خديجة واستقر في مكة. وكان جبريل ينقل الوحي إلى محمد r. وأصل الرسالة هو التوحيد أي (لا إله إلا الله). ويرى توينبي أنه بموجب الرسالة التي حملها محمد rإلى أتباعه فإن أول ما يطلبه من الذين يعتنقون الرسالة هو إسلام النفس إلى الله (وهذا معنى كلمة الإسلام العربية)…وهناك الواجب المترتب على الأغنياء والأقوياء نحو الفقراء والضعفاء، مثلاً نحو الأرامل واليتامى..
هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة الإسلامية وهي المرحلة المكية التي كانت دينية خالصة تجسدت فيها قوة الإسلام الروحية، وتميزت فيها ملامحه القادمة.
المرحلة الثانية: هي المرحلة السياسية في حياة محمد r، في هذه المرحلة التي طغت فيها روح (الدولة) على روح الدين الجديد، وتحولت الدعوة من الإيمان بالله إلى (القتال) في سبيله. وقد بدأت هذه المرحلة كذلك (باعتكاف) النبي وهجرته من مكة إلى المدينة واستؤنفت على أشدها عند (عودته) إلى مكة فاتحاً بعد سبع سنوات من (الاعتكاف) من عام 622-629. يقول تيونبي: “الدولة ذات السيادة تشن الحروب. ولم يتوان محمد وقد أصبح الآن حاكماً (في يثرب) في شن حرب ضد أهله المكيين. وكان ثمة احتمال في أن ينجح، وقد نجح فعلاً، هذا النجاح هو الذي أدخل الدين في السياسة والحرب”..
غير أن حركتي (الاعتكاف – والعودة) اللتين قام بهما الرسول في حياته تختلفان في نظر توينبي اختلافاً يعده ظاهرة شاذة في تاريخ الحضارات كلها: ففي المرحلة الأولى (اعتكف) محمد r تاجراً (ليعود) نبياً. وفي المرحلة الثانية (اعتكف) نبياً (ليعود) فاتحاً سياسياً. وبذلك تكون الهجرة كما يراها توينبي بدء انحدار الإسلام لابد تأسيسه كما هو شائع بين المؤرخين…
إن توينبي إذ ينظر إلى حياة محمد r ونمو الدعوة الإسلامية في مرحلتين مختلفتين اختلافاً واضحاً ومتناقضتين في جوهرهما تناقضاً خطيراً، حسب ما يعتقد، إنما يكرس في تلك النظرة المتعالية عن حقائق التجربة، وجهة نظره الاستشراقية المسيحية المتعصبة للدين الذي يجب أن لا يرتبط بأية غاية سياسية أو هدف دنيوي، وتوينبي بذلك لا يختلف عن غيره من المستشرقين أمثال ماكس فيير الذي كان يرى “أن عنصر الخلاص في الإسلام قد تحول إلى طلب علماني في الأرض، ومن ثم تحول الإسلام إلى دين توافق وتكيف أكثر منه دين تحول، وأنه بالرغم من ظهور الإسلام في مكة ديناً توحيدياً تحت إشراف محمد r إلا أن الإسلام لم يتطور إلى دين تزهدي لأن حملته الأساسيين كانوا طبقة محاربين، بل أن محتوى رسالته قد تحولت إلى مجموعة من القيم التي تتفق مع الحاجات الدنيوية لطبقة المحاربين”..
ويرى المستشرق برتران بادي في كتابه (الدولتان الدولة والمجتمع في الغرب وفي ديار الإسلام) أن الحضارة الإسلامية تفرض نفسها بوظيفتها المزدوجة العسكرية والدينية، فبدل أن تعزز الممارسات الجمعية، والتضامنات الأفقية، قدمت كل العناصر القابلة للانفجار والانقسام، من خلال النخب الدينية، ومن خلال إعادة تشكيل العصبيات في الحي، وتدفع إلى تضامنات عمودية مذهبية أو موالاتية وتتحول لعبة المعارضة، أمام الإخفاق الشامل إلى ضرب من الهيجان. ويخلص المؤلف إلى القول: “إن الطوباوية الناجمة عن الراديكالية الإسلامية، يستحيل عليها أن تهيئ نموذجاً عن مدنية، وأن تتجاوز مرحلة (الثورة المستمرة)، مؤكداً أن البديل الذي يواجه المجتمعات الإسلامية ينحصر بالاختيار بين محاكاة الحداثة وخطر التموضع خارجها”..
إن توينبي الذي يفسر الحضارة الإسلامية من خارجها، وينظر إلى سيرة حياة محمد r من زاوية رؤية مقارنة تجعل من السيد المسيح والمسيحية مثالاً أعلى لقياس العينات وضبط التوافقات والاختلافات، لم يكن له أن يدرك العوامل والشروط التاريخية والسيكولوجية والدينية التي حتمت على النبي r الجمع بين الدين والسياسة، بين الأرض والسماء، بين الاعتقاد والسلوك، بين مدينة الله ومدينة الإنسان، بين الله وقيصر، بين الضرورة والشريعة، بين المرحلة الدينية والمرحلة السياسية، بين مكة والمدينة. وبسبب عجزه عن فهم الأوليات الداخلية والأسباب المتخفية التي حتمت ذلك على الرسول r الذي لو لم يفعل ذلك لما كانت الدعوة الإسلامية لتنتصر بهذه السرعة…
إذ يقول توينبي في تعليقه على المرحلة السياسية من حياة محمد r: “إن الدولة التي أسسها محمد r بعد عودته من المدينة إلى مكة شبيهة بالدولة التي أسسها قيصر بعد عودته من بلاد الغال إلى روما”
ويتابع توينبي عقد المقارنات بين المسيحية الإسلام عاداً أن المسيحية ظلت على العموم أمينة للآية القائلة: “أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله”. أما قيام الدولة الأرثوذوكسية والبروتستانتية في القرون الوسطى رغم أنه خرق لروح الآية لم يبلغ الدرجة القصوى من توحيد الدولة والدين في التاريخ الإسلامي في كيان مؤسسة سياسية واحدة. ونظام شمولي عضوي صارم”..
هذه التصورات عن الإسلام هي التي انتقدها المستشرق الأمريكي (نورمان تسيغر) إذ يرى أن بعض المستشرقين قد سوغوا إفناء المسلمين في البلقان من خلال الترويج لمثل تلك الطروحات التي تذهب إلى (أن المسلمين ينتمون إلى ديانة / ثقافة غريبة) وأن (المسلمين لا يمكن أن يكون لهم مكان في أوربا) وأن “الإسلام نظام شمولي، حتى أن شموليته لا يمكن لأي روح غربية أن تتفهمها أو تتخيلها”..
إن توينبي إذ يأخذ على النبي محمد r خروجه عن المبدأ العام الذي حاول تطبيقه على جميع الحالات المشابهة الأخرى عند الأنبياء والرسل والشخصيات الخلاقة التي كانت حركة الاعتكاف والعودة بالنسبة لها “تعني حالة الارتقاء بالنفس والتسامي الروحي، لا حالة انحدار تهبط إليها النفس كما هبط محمد من علياء النبوة إلى دنيا السياسة بعودته من المدينة إلى مكة”().
ومن الإنصاف الإشارة إلى أن توينبي قد انتقد تلك الآراء التي تبالغ في تقدير القوة التي استخدمها الإسلام لتأمين انتشاره، إذ يرى “أنه إذا كان اعتناق الإسلام إجبارياً في الجزيرة العربية، فقد كان أكثر تسامحاً في البلدان التي تم فتحها، وأن المبدأ الذي اتبع فيما أخضعه الفتح لم يكن الاختيار بين (الإسلام أو الموت) بل كان التخيير بين الإسلام والجزية، والإسلام استطاع أن يشق طريقه بين الأعاجم من رعايا الخلافة الإسلامية معتمداً على كفاءاته الدينية الخاصة دون اللجوء إلى السلاح”..
ثانياً: يحذر توينبي من التسليم الذي شاع في الغرب، بأن محمداً قد ادعى النبوة لغاية وصولية هي اعتلاء عرش الدولة الإسلامية، ويرى أن “نبياً يثبت في دعوته مدة ثلاثة عشر عاماً (609-622) محتملاً كل صنوف الآلام والمخاطر والتعرض للموت لا يمكن إلا أن يكون عامر النفس بإيمان ديني صادق عميق”()..
ويمكننا إدراك أهمية تحذيرات توينبي إذا عرفنا الصورة التي تم تكريسها عن الإسلام في الثقافة الغربية وهذا ما يكشف عنه المستشرق الفرنسي (موريس بوكاي) في كتابه (دراسة الكتب المقدسة القرآن والتوراة والإنجيل والعلم) بقوله: “إن المعطيات الخاصة بالإسلام مجهولة عموماً في بلادنا الغربية، ولا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا الطريقة التي اتبعت في تثقيف الأجيال الكثيرة فيما يتعلق بالدين الإسلامي وكيف فرض عليهم الجهل في كل ما يمس الإسلام، والاستعمال السائد حتى اليوم في تسميات مثل (الدين المحمدي) و(المحمديون) أو (ماهومت) إنما ليدل دلالة عميقة على تلك الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطئ القائل أن تلك المعتقدات انتشرت بفضل جهاد رجل، وأنه ليس لله بالمعنى الذي يدركه المسيحيون مكان في تلك المعتقدات”()..
وفي نقده للتعصب الديني ذهب توينبي إلى القول “أن قيام دين يقال عنه أنه دين حق باضطهاد دين يدعى بأنه باطل، أمر يناقض في صميمه طبيعة العقيدة الدينية لأن الدين الحق إذ يلجأ إلى سلاح الاضطهاد، يضع نفسه في المكان الباطل، ويتخلى عن مقوماته، ويشيد بما فعله محمد r حين أمر أتباعه بالتسامح الديني تجاه اليهود والمسيحيين فقدم محمد r بذلك لقاعدة التسامح تفسيراً قوامه أن أفراد هاتين الجماعتين الدينيتين غير المسلمتين هم أهل كتاب كالمسلمين أنفسهم وليس أدل على “روح التسامح التي بعثت الحياة في الإسلام منذ بدايته، من أن المسلمين قد طبقوا مبدأ التسامح الديني على أتباع زرادشت الذين خضعوا للحكم الإسلامي وإن لم يقل بذلك الرسول الكريم”()…
ويتابع توينبي رصد تطور الحضارة الإسلامية بعد وفاة الرسول r، (إذ تغلبت قوات المدينة ومكة المشتركة على المرتدين) وكانت سرعة الفتوح التي تمت على أيدي المسلمين ومداها أمرين يدعوان إلى الإعجاب، فقد انتزع العرب من الإمبراطورية البيزنطية سورية والجزيرة (الفراتية) وفلسطين ومصر إلى سنة 641، وكان العرب قد فتحوا العراق (637) وإيران بأكملها حتى مرو سنة 651. وفي سنة 653 أسلم الأرمن وسكان جورجيا، وبين عامي 647-698 انتزع العرب شمال غرب إفريقيا من البيزنطيين. وفي سنوات 710-712 اجتازوا البحر إلى شبه جزيرة إيبريا وقضوا على مملكة القوط الغربيين واحتلوا أملاكها حتى الواقعة في جنوب غرب بلاد الغال. وفي الوقت نفسه عام 711 كان العرب يفتحون حوض السند ومنطقة البنجاب الجنوبية بما في ذلك الملتان. وبين سنتي 661 و671 فتح العرب طخارستان (شمال غرب أفغانستان)،..
وفي السنوات 706 – 715 اتجه العرب نحو ما وراء النهر لفتحها. تمكنوا من فتحها عام 741، وفي العام 741 وقفت الفتوحات العربية عند جبال الأمانوس، وفي عام 718 فشل العرب في فتح القسطنطينية للمرة الثالثة، وفي سنة 732, ردوا في بلاط الشهداء (بواتييه – تورو) كما أنهم عجزوا عن فتح إمبراطورية البدو والخزر (بين نهري الفولغا والدون). في 737-738 وهكذا يقول توينبي: “فقد توقفت الفتوح العربية عند حدود معينة، إلا أنها كانت فتوحاً سريعة وواسعة في مجالها.. والسلطان الذي كان اليونان قد تمتعوا به مدة 963 سنة في الشرق، منذ فتوح الإسكندر وضعت الفتوحات العربية سنة 633 حداً له”…
مقتطف من الكتاب في الفصل الخامس….
 منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس موقع اخباري حر