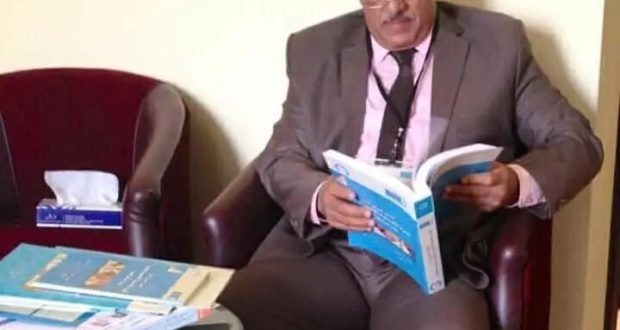افهم ما تقرأه وأكتب ما تشعر به..
تأملات في الفرق بين ثقافة الكلام والكتابة..
الكاتب / بروفيسور : قاسم المحبشي ..
حينما كنت مراهقا لم يكن شغفي بالقراءة في سبيل فهم المكتوب، بل كان بغرض النسج على منواله. لكنّي بمجرد ما أضع الكتاب الذي كنت منشغل بقراءته جانبا وأمسك القلم وأهم بكتابة أفكاري الخاصة التي استلهمتها من وحيه؛ حتى تضيع الفكرة وتضطرب العبارة فاصرف النظر عن محاكاة كتابة أفكار الآخرين..
وهكذا استمر الحال إلى أن: قرأت ذات يوم حكمة بليغة تقول:( أفهم ما تقرأ وأكتب ما تشعر) ومن حينها ادركت إن القراءة تعلم الفهم والفهم يثقف المشاعر والمشاعر تحفز الخاطر للكتابة. وأفضل الكتابة هي تلك النابعة من قراءة واسعة وثقافة معمقة ومشاعر صادقة وفكرة واضحة وتجربة معاشة…
تداعت هذا الفكرة إلى ذهني وأنا أقرأ منشورات بعض الأصدقاء والصديقات في هذا الفضاء لاسيما من الحاصلين على درجة عالية من بالتعليم الأكاديمي، إذ وجدت أن بعضهم يكتب وينشر نصوص وافكار ليست نابعة من ذاته وقناعاته ولا تعبر عن مسوى فهم للعالم لاسيما لمن يعرفه ويعرف طريقة تفكيره وأسلوب تعبيره عن افكاره شفهيا فالثقافة الشفاهية تعلي من شأن الخطابة والحفظ والتلقين والتذكر باعتماد على الأنماط التعبيرية القابلة للحفظ والتذكر، فالمرء الشفاهي لا يمكنه تذكر إلا عبارات وكلمات محدودة ومسموعة ومكررة ومنمطة وكلما زاد الفكر المنمط شفاهياً تعقيداً زاد اعتماده على العبارات الجاهزة المستخدمة بمهارة في أقوال معتمدة على الصيغ (حكم وأمثال واقوال وشعارات وصيغ وعبارات) ولهذا السبب تزدهر في الثقافات الشفاهية أنماط ثقافية محددة، مثل الشعر والحكم والأمثال والحكايات والأساطير والسجع والأهازيج والتهريج.الخ..
ومن سمات الثقافة الشفاهية بمكن الأشارة إلى : ١- عطف الجمل بدلاً من تداخلها، اذ تكثر حروف العطف بشكل ملحوظ.
٢- الأسلوب التجميعي بدلا من التحليل العقلاني. ٣- الأسلوب الإطنابي أو الغزير بدلا من الاختصار والتحديد والوضوح في القول والمدلول كما جاء في المثل ( خير الكلام ما قل ودل!)
٤- الأسلوب التقليدي المحافظ بدلا من الانفتاح على العالم والآخرين وتجديد الفهم.
٥- القرب من عالم الحياة والشخصنة وردود الأفعال والانفعالات المباشرة بدلا من التجريد الرشيد.
٦- غياب التمييز بين الكلمات والأشياء، بين الدوال والمدلولات يقول موريس بلانشو، أن الكلمة في اللغات الأصيلة ليست تعبيراً عن شيء بل هي غياب هذا الشيء.. إن الكلمة تخفي الأشياء وتفرض علينا إحساساً بغياب شامل بل بغيابها هي ذاتها..
هناك نمط من الأشخاص غير قادر على معرفة هذة الحقائق البديهية، حيث تكتسب الكلمات لديهم معاني محددة سلفاً وثابتة،وتجدهم يطابقون بين الكلمة والشي الذي يعتقدون انها تدل عليه، يطابون بين الدال والمدلول، بين اللفظ والواقع الذي قد منحوه في وقت سابق من تاريخهم جل احترامهم أو تقديسهم أو نفورهم، ومن ثم تجدهم اكثر هياجاً عندما يتم ذكر هذا اللفظ بقليل من الاحترام أو النقد، أو الحديث عن اللفظ الذي كان يثير ردود فعل ساخطة عندهم، بشي من الاحترام. فإذا كان السيد “س” اشتراكياً، والسيد”ص” اسلامياً سياسياً، فان نقد الاشتراكية يثير غضب الأول ويسر الثاني والعكس صحيح. أن مثل هذة الإشكال من التجارب الثابتة مع الكلمات هي نوع من التحيز والتعصب الأعمى، ومثل هؤلاء يبدو وكان لديهم في ادمغتهم نقطة مكشوفة بحيث انها لو مست بكلمات لا يرغبون بها يصير بها نوع من التماس الكهربائي الذي يحترق معها المصباح الكهربائي” المين سوتش”كله..
ويعتقد الفريد” كورز يبسكي” مؤسس علم تطور المعنى العام”: أن مثل هذا النوع من الاستجابات المكهربة: هي استجابة التسوية في الهوية، ونحن نسمي هذا”ثقافة البعد الواحد” حيث يطابق أولئك الأشخاص بين جميع أنواع الحدوث لكلمة ما أو رمز ما ويرون فيها شيئاً واحداً لا يتغير، فهم يساون بين مختلف الحالات التي تقع تحت ذلك الاسم ذاته على انها شي واحد.غير ان هذة الثقافة أحادية البعد، هي سمة فسيولوجية في الجهاز العصبي للانسان المتوحش، الذي ظل لزمن طويل يعتقد بالقوة السحرية للكلمة..
فالصيغة السحرية لم تكن تفعل فعلها الأ من خلال الاعتقاد الراسخ بقوة الكلمات على الخلق والفعل.
٧- شيوع لهجة المخاصمة والتعصب والانحياز وغياب الحياد الموضوعي.
٨- تكرار الاحاديث ذاتها في كل المقامات والاحوال، والعزوف عن القراءة البصرية وتفضيل الاستماع للأحاديث الشفوية فالكثير من نجوم السوشيل ميديا اليوم لا يجيدون القراءة والكتابة الابجدية.
٩-ارتفاع نبرة الصوت في المحادثات، عدم الوصول الى اتفاقات حول الموضوعات المختلف بشأنها وكلما كان المرء غير واثق من الاشياء التي يتحدث عنها كلما زادت نبرة صوته ارتفاعا ,وكلما افتقد المرء للبراهين والحجج المقنعة ,كلما زاد صراخه في تأكيد آراءه ومعتقداته الأيديولوجية بينما لايحتاج عالم الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء الى الصراخ والاصوات العالىة للتعبير عن حقائقه وقوانينه العلمية..
فالصمت هو سيد العلم الحقيقي والضجيج هو سيد الاعتقادات الايديولوجية. ولكن ليس هناك إلا طريقتان لتوصيل افكارنا الى الأخرين :أما أن نجبرهم على قبولها بالتهديد والتخويف والوعد والوعيد وأما أن نجعلهم يقتنعون بها بقوة البرهان والاقناع المتولد من أرادتهم الحرة بدون جبر أو اكراه من أي نوع كان والسلام على من يفهم الكلام بلا لف ولا دوران…
١٠- الشغف بالحكي والثرثرة في كل الأمور والاحوال مع الاهتمام بالألفاظ وإهمال المعاني.
١١- الأهتمام بالمنطق بدلا من الواقع، بإفحام الخصوم بدلا من إصلاح القصور ، بصياغة الشعارات بدلا من بناء المشروعات.
وهكذا هو الحال في الثقافات الشفهية يغيرون الكلمات حينما يعجزون عن تغيير الواقع وتختلف الأحاديث والنثرات عن بعضها بعدد من السمات فمنها: ما هو جميل ومنها ما هو ردي، وبعضها يجذب الاهتمام ويبعث على الدهشة والفرح والجمال وبعضها يثير القرف والضيق والتوتر والاحتقان. فليس الكلام على درجة واحدة من القيمة والمتعة والجدوى والأهمية والجدارة. فاحيانا قد نستمع لشخص يتحدث برغبة واهتمام بل قد يسحرنا كلامه ربما بأسلوب الخطابة وربما بجزالة اللغة وربما بفصاحة اللسان وربما بنبرة الصوة وربما بقوة الحجة وربما بلغة الجسد وإيماءاته الحركية الرشيقة. وربما باشياء أخرى تختلف من مستمع إلى أخر ولهذا قيل ( أن لمن البيان لسحراً) وحينما تزدهر الثقافة الشفاهية تزدهر معها أدوات وأساليب التعبير وفنون الخطابة؛ الزوامل والشيلات والمناجمات والشعر والسجع والبلاغة والخطابة والمنطق..
وفي زمن هيمنة الكلام المباشر قبل الكتابة قال حكيم اليونان سقراط: ( تكلم حتى أرك) وفي ذات السياق نفهم معنى الحكمة العربية ( المرء مخبوء تحت لسانه) وفي ذلك قال الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى
(لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
ولم يبق إلا صورة اللحم والدم )
وقيل بالأمثال : لسانك حصانك إن زلت زل! فكيف هو الحال مع النص وماذا تعني الكتابة في مقابل الخطابة؟ وظيفة الكتابة جمع المبعثر كما كتب شوقي الزين ” المنطلق اللغوي للكتابة هو «الجمع». هناك شيء ما مُبعثر يتطلب الجمع. هذا الشيء المبعثر هو مجموع الخواطر الشريدة التي تتردَّد على الذهن في تدافع وتزاحم وتسارع، تنتظر الانتقاء ثم التنظيم وأخيرًا الترتيب في رؤية معقولة تكشف عن فكرة ناظمة. في الأصل، الكتابة هي إذًا تنظيم مجرى الخواطر والأفكار، مثلما يُنظِّم قانون المرور مسرى المركبات والمُشاة..
هناك تماثلٌ بين بنية الكتابة وبنية الحاضرة، حيث تقوم علامات الوقف من نقطة وفاصلة ونقطة-فاصلة مقام قانون المرور؛ لأن الكتابة التي تُجسِّد الأفكار، تُثبِّت كذلك قوانين انتظامها وتسلسلها من كل الوجوه النحوية والأسلوبية والمنطقية، تمامًا مثلما أن النظام الحَضَري للمدينة لا يستقيم ما لم تكن الشارات هي الدليل والمرشد في تنظيم الحركة ودرء الحوادث. الكتابة هي الشارة الأساسية في تفادي حوادث المعنى. ليست علامات الوقف والعلامات اللغوية موضوعة ترفًا أو جماليًا، بل تؤدِّي بالفعل قيمة دلالية، لأن وضعها في المكان المناسب لها هو التدليل على فكرةٍ من وجه التدعيم أو التفنيد، من وجه الإثبات أو الإقناع، إلخ”..
 منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس موقع اخباري حر