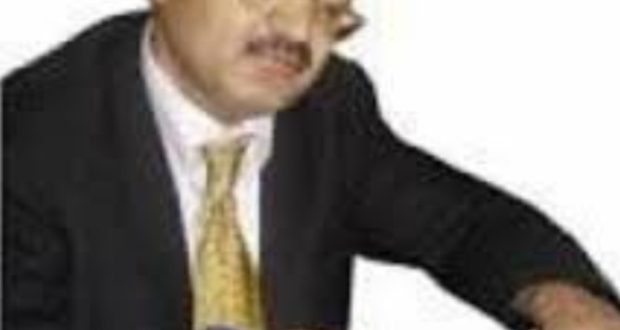الكاتب / احمد البكري….
في كتابه المُعَدّ للطبع تحت اسم “أبو الروتي”يستعيد عبدالكريم الرازحي ذكريات الطفل الذي كان، ذلك الطفل الذي نزل إلى عدن للدراسة واضطرته ظروف الحياة القاسية وهو طفل أن يذهب إلى عدن ليعمل في أحد الأفران، إلى جوار دراسته في مدرسة البادري، ومن خلال تلك الأحداث التي عاشها ويسردها متصرفاً بحركة الزمن فيها، يصوِّر جوانب من الحياة ومن علاقات الناس ببعضهم بعضا، وجوانب مما كانت عليه نظرته للحياة آنذاك ونظرة الآخرين إليه وهو الآخر القادم من الجبال إلى عدن المدينة الساحلية المكتظة بالأضواء والبشر من كل الجنسيات، وكيف كانت دهشة الطفل الذي كان، وكيف واجه ثقافة المكان الجديد، وتبع فضوله ورغبته في أن يكتشف ويرى ويخالف كل ما يملى عليه من تعليمات، وكانت جنة السينما أول خطواته إلى عالم الدهشة، غير عابئ بكل التحذيرات التي تحاصره وتذم لها السينما ومن يرتادونها.
بالسخرية يلتفت الرازحي إلى التعليمات التي تحاول أن تمسك به وتصادر حريته، ويلقي في وجهها ببعض الكلمات العابرة لتضحك وتتركه يركض، لا يريد بسخريته أن يفعل شيئاً غير أن تسترخي قبضة الحياة قليلا ليهرب بعيدا ويواصل الركض.
في كتابه هذا، ليس للرازحي أي علاقة بما يُقال عن السخرية التي يقول بعض الدارسين إنها تُستخدم سلاحاً للنضال؛ فالرازحي كعادته في كل ما يكتبه يفضِّل أن يظل أعزلاً وبلا معركة وبلا انتصارات، لا يبحث عن نياشين ولا أوسمة ولا يحاول أن يهزم أحدا، ولم يحاول الاصطفاف مع أحد، ولذلك ظل حراً في كل اتجاه، وفضَّل أن يكون وحده رغم رتابة الأشياء في كل مكان.
لدى الرازحي الكثير مما يمكن أن يقوله متوجعاً أو ساخطاً لكنه رغم مرارة ما عاناه من الحياة منذ طفولته يجعل الذاكرة المكتظة بالألم تتهكم وتسخر بأقل الكلمات وأقربها إلى التعبير، وأحسبه يكتب ذلك كما لو أنَّه ما يزال يستنفر الذاكرة ليعرف إلى أي اتجاه يركض الزمن الآن وكيف لإرادة الحياة أن تنتصر على ألم الجراح مهما كانت غائرة.
في ذكريات الرازحي التي جعل مركز الحكاية فيها “أبو الروتي” نجد المعنى متخففاً من إرادة إرضاء الآخرين، معنى يسجِّل لحظة شعور ولا يبحث عن إعلان موقفٍ أو تسجيل رأي، أو انتزاع أيِّ اعتراف من أيِّ نوعٍ كان، يكتب ويمضي ويترك وراءه بين السطور فسحةً للابتسامة.
والسؤال: هل ما يضحكنا في كتابة الرازحي قدرته على أن يشعرنا بغفلتنا قياساً بشخصيات تشبهنا في ثنايا هذه الذكريات؟ أم يضحكنا استخفافه بالقيود التي يضعها المجتمع والرمزيات التي يصنعها؟
هذه الكتابة لم يسمها الرازحي، ولم يحرص على أن يكون لها أي إطار أو يضع لها أي قيد. وبين استعادة نظرة الطفل الذي كان والتعبير عما آل إليه الحال، وبين حياته في عدن وحياته في القرية يحدث الاسترجاع والتداعي للأحداث وتوقظ بعض الكلمات ما كان نائماً في الذاكرة، حتى بإزاء أحداث وتحولات كبرى مرَّ بها الوطن:
“كانت أمي في صباح يوم الخميس 26 سبتمبر 1962، قد أيقظتني من النوم وراحت تلومني وتقول لي وهي تتحسس فراشي المبلول -“الثورة قامت وأنت مكانك تبول.”ولحظتها ترجم عقلي كلمة الثورة على أنها البقرة – أنثى الثور – وخطر في بالي أن بقرتنا التي كانت مريضة، تعافت من مرضها ففرحتُ بقيامها وقلتُ لأمي:”هل شفيتْ ؟”
قالت أمي:” الثورة قامت والبدر هرب من القصر”.
كان لبقرتنا البيضاء التي ماتتْ عِجْلٌ اسميناه: (بدر)، وبقدر ما فرحت بقيام الثورة، زعلت حين قالت لي أمي إنَّ البدر هرب من القصر. وكان عقلي قد ترجم لي كلمة القصر على أنه الإسطبل. وفهمت من كلامها أن عِجْلنا (بدر) هرب من الإسطبل ولأنها كانت زعلانة مني لأني تبولت على الفراش. قلت أسترضيها وأخفِّف من غضبها عليَّ، وأخرج بعد العِجْل الهارب وأعيده للإسطبل وقلت لها :
– “ولا يهمك، يا أمي أنا سأذهب وأعيده إلى الإسطبل”.
لكن أمي بدت مستغربة من كلامي وقالت لي:
– “تخرج، وتعيد من؟”
– قلتُ لها: أرجِّع بدر، مش قلتِ إنه هرب من الإسطبل!”
وحينها تعجبت أمي من غبائي، وقالت لي إن الذي هرب هو الإمام (محمد البدر) ملك اليمن وليس (البدر العِجْل) لكن عقلي لم يستوعب ما قالته فقد كنت أعرف أن (الإمام) معه عسكر وجيش والناس يخافون منه ومن عساكره وهم الذين يهربون منه، وقلت لأمي :
-“كيف هرب وهو ملك ومعه عسكر ومعه جيش!”
قالت أمي بنبرة حادة :”قلت لك: الثورة قامت؟”
ولأن الثورة التي تتحدث عنها أمي كانت قد ترسخت في عقلي على أنها بقرة، رحت أسألها وأقول لها :
“- الإمام هرب من الثورة حقنا، وإلا من حقه الثورة ؟”
ولحظتها استشاطت أمي غضباً من غبائي وقالت لي :
-“هل أنت أهبل، يا (عبد الكريم)؟” وراحت تشرح لي معنى الثورة وقالت إنَّ الناس الذين يحكمهم الإمام خرجوا عن طاعته وعصوا أمره وأصبحوا ضده بسبب ظلمه وأرادوا قتله، وهو هرب من قصره وشرحت لي معنى القصر، وقالت لي إنه ليس إسطبلا مثل اسطبل البقر وإنما هو دار ضخم من عدة طوابق يقيم فيه (الإمام) وعندئذٍ عرفتُ أنَّ كلمة الحرية التي وردتْ في حديث الرجلين قريبةٌ من معنى كلمة الثورة التي شرحتها لي أمي. وكانت كلمة الحرية قد ترددتْ عدة مرات في حديث الرجلين حتى لقد حفظتها وكانت أول كلمة تستقر في ذاكرتي وتلامس شيئا في نفسي من قبل أن أعرف معناها”.
تلك السخرية من حدث الثورة ومن الإمام الهارب كعِجْل تبدو عفوية، لكنها توقفنا على الحدث وإعادة تقييمه والنظر في أبعاده، وفي الوقت نفسه تحفزنا ونحن نبتسم على إيجاد علاقة بين نظرة الطفل عبد الكريم الرازحي للثورة التي لم تكن يومها بالنسبة له أهم من البقرة وما يستبطن هذه الإيماءة من معنى تلك الثورة التي صارت بقرةً حلوب بعد ذلك.
مثل ذلك نجده في موقف آخر يرويه لنا، ساخراً من التبرك بالأولياء:” كان (السيد هاشم) سيدا عابرا للقرى ومشهورا في قريتنا وفي قرى ناحية (القَبَيْطة) بكراماته وبقدرته على شفاء الأمراض التي لا شفاء منها. كان اسمه محاطا بهالة من القداسة حتى أنَّ الناس من قريتنا، ومن جميع قرى الناحية، كانوا يقدسونه، ويلوذون به، ويفزعون إليه، ومنه ينتظرون الشفاء من أمراضهم وينذرون له النذور. وكان يكفي من المريض أو من قريبه أن ينذر له نذرا ويتواصل معه روحياً ويطلب منه أن يشفيه من مرضه عن بعد ومن دون أن يذهب إلى قريته. وهذا ما فعلته جدتي بعد عودتي.. بعثت له بهدية.. وتواصلت معه روحياً وطلبت منه أن يشفيني ويمن عليَّ بالشفاء. وذات ليلة استدعتني وقالت لي بأني قد شُفيت بفضل كرامة (السيد هاشم) وطلبتْ مني ليلتها أن أنام عندها في المفرش لتثبت لي صحة كلامها. وفي الصباح حين اكتشفت بأني تبوّلت، بدت محرجةً مني وكنت أنا محرجًا منها كوني فعلتهافي بيتها. لكن جدتي راحت تبرر ما حدث وتقول إنَّ (الحَمَّار قاسم سيف) لم يوصل الهدية ولو أنه أوصلها لكنتُ شفيتُ من عاهة التبول. و(قاسم) هذا الذي ألقت جدتي باللوم عليه هو حمَّار عابر للقرى ويقوم بدور ساعي البريد ينقل الرسائل والأخبار من قرية إلى أخرى. وكانت جدتي قد أرسلت معه الهدية (للسيد هاشم) والمؤكد أنه كان قد أوصلها إليه، لكنَّ جدتي يستحيل أن تعترف بهزيمتها أو بهزيمة (السيد هاشم) وعجزه عن حبس البول في مثانتي وهو المشهور بكراماته العابرة للقرى، وبقدرته على ربط ما هو أعظم من مثانة طفل”.
في مشهد آخر سنجد مرارةً سافرةً في ثنايا السخرية؛ فقد كشف معاناة الطفل عبد الكريم الذي جاء من القرية الفقيرة فجأة إلى عدن المدينة، وكانت صدمته من أول يوم، وقد وقف أمام لحظةٍ جعلته يتأمل قسوة الفقر، ويحس بالمسافة بين واقعه وبين رغباته، بين صورته المشوهة في عين الآخر وحاجته إلى أن يبحث عن فرصة حياة في هذه المدينة التي لا تأبه به.
“كان (سوق الطويل) شارعًا مزدحماً بالناس والدكاكين ولأنَّ وقت المغرب كان مازال بعيدا لم أكترث بضياعي ولم أقلق لعدم معرفتي طريق العودة. وكنت على يقين بأني سوف أعثر على طريقي حين يحين وقت عودتي رحت أتلفت يمينًا وشمالًا أبصرت طفلاً بعمري يمرَّ من جنبي راكبًا آلةَ حديدٍ لها عجلات. ولحظة رأيته فرحتُ ورحتُ أجري خلفه حتى لا يختفي ويغيب عن ناظري. جريت بأقصى ما أستطيع لألحق به، لكن آلته كانت أسرع مني وأسرع من حماري الذي أخذه السيل في (وادي الشوَّيْفَة). وفي الأخير وقد يئست من اللحاق به توقف عند أحد الدكاكين وعندئذٍ جريت ناحيته وقلت له وأنا ألهث من التعب:- “أيش هذا؟” قال: “سيكل” قال لي وهو مشمئز من مظهري القروي ومن سؤالي الغبي.
قلت: “هاااااا هذا سيكل؟ وشعرت في قرارة نفسي برغبة عارمة في ركوب هذه الدابة المصنوعة من الحديد والتي تتفوق على حماري في سرعتها. وبدافع الفضول رحت أحملق في سيكل الولد العدني وأدور حوله وأتمسح به ثم مددت يدي ورحت ألمسه وأتحسسه بنفس الطريقة التي كنت أتحسس بها حماري، لكن الولد العدني حين أبصرني وقد تماديتُ راح يهش يدي وكأنها ذبابة ويقول كلاما بالعدني لم أفهم منه سوى كلمة واحدة “جَبَلِي”ولم أكن أعرف ماذا يقصد بقوله لي بأني جَبَلِي ولم يخطر ببالي أنها شتيمة، لكني شعرتُ من نظراته ومن تعابير وجهه بأنه قد ضاق بي وبوجودي قريبا منه. كان في نيتي وأنا أركض خلفه أن أسأله عن سيكله وهل اشتراه أم اكتراه، لكنَّ السؤال تجمّد طرف لساني بعد أن رأيته يهشُّ يدي ويبعدها من فوق دراجته كما لو أنها ذبابة. ومع أن شعورًا بالغضب كان يدفعني للاشتباك معه بسبب الطريقة التي عاملني بها إلا أن صوتاً في داخلي كأن يمنعني ويقول لي: “لا، أنتبه هذا عدني”. وشعرت لحظتها أن هناك مسافةً بيني وبين الولد العدني.. بين القرية التي جئتُ منها.. وبين المدينة التي ينتمي إليها.. بين حماري وبين دراجته. بين مظهري القروي البائس.. وبين مظهره المدني المترف، بين حضوري البليد وبين حضوره الذكي والمدهش. لكني بعد أن تركتُه وعدت إلى(سوق الطويل) تنامى لديَّ هذا الشعور بالمسافة. وبقدر ما كنتُ أحاول الاقتراب من الناس كانوا يبعدون. وكلما وقفتُ للسلام وللكلام يمرون من جنبي مرور اللئام فلا يردون السلام مثل أهل قريتنا ولا يسلِّمون”.
هذا الكتاب مشاهد وثَّق فيها الرازحي جوانب من حياته التي كانت تشبه حياة معظم اليمنيين، لكن الفرق أنَّ الرازحي لديه ذاكرة خاصة وعين خاصة وإحساس خاص وبذلك أعاد كتابة سيناريو حياته وتدخل في المونتاج لصالح الأمل، وأخرج معاناته ومكابداته ساخراً متأملاً.
وأشرك المتلقي في تأمل جراحاته وعذاباته وإرادته التي استطاعت أن تتهكم على كل ما يريد أن يصادر استقلالها وبساطتها وجرأتها على أن تظل واضحةً وعالية.
ولعلَّ أول ما يسترعي انتباه المتلقي تلك الانتقالات التي تجعل إيقاع الحكاية متسارعاً ومتداخلا؛ فالمشهد ينفتح على آخر، والاستطراد في حكايةٍ يستدرج إلى أخرى، ورغم كل ذلك، أي بين الاستبطان والإعلان تنضِّد ذاكرة الرازحي جروحها وإخفاقاتها في رؤية خاصةً لمقاومة الانكسار الذي لا تخجل منه ولا تتركه يهيمن على خط سيرها في الحياة.
سخرية الرازحي في هذا الكتاب سخرية الإحساس الجامح، سخرية القفز على الحواجز التي يرفعها المجتمع بين الكلمات والحياة، سخرية التخفف من الإكراهات والتنميطات والقوالب…
 منشور برس موقع اخباري حر
منشور برس موقع اخباري حر